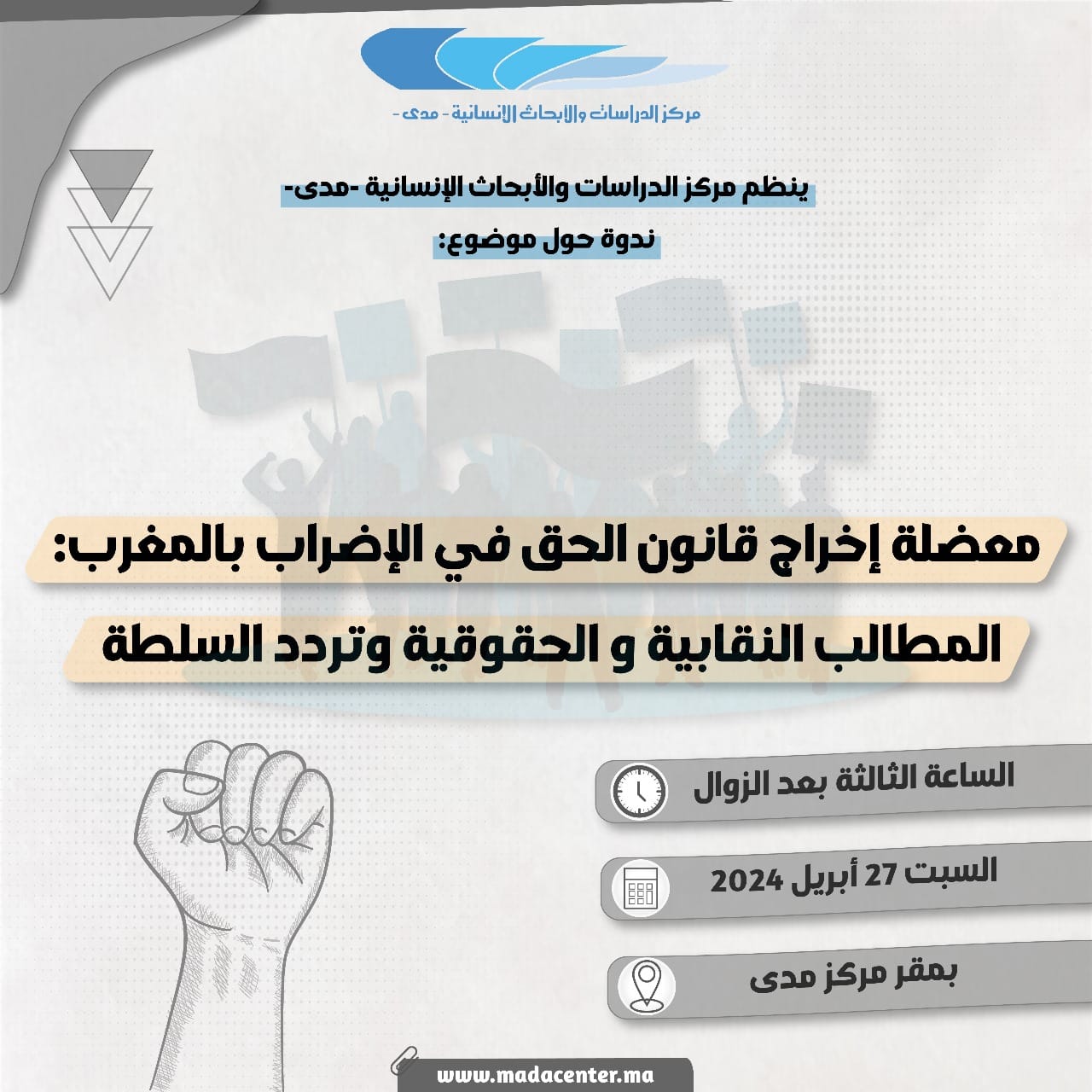حوار العدد 48 من مجلة رهانات مع الفيلسوف المغربي "محمد سبيلا"
محمد جليد: أستاذ سبيلا، أعتقد أن السجالات التي أثيرت في الصحافة، في الساحة الثقافية والإعلامية المغربية حول القيم، الهوية، الدين، اللغة وغير ذلك هي سجالات قوية. وأعتقد أن المشكل فيها يتمحور حول المنطلقات المرجعية، الأيديولوجية، والسياسية في المغرب. فإلى حد يمكن اعتماد المرجعيات السياسية منطلقا لتفسير هذه السجالات؟
سبيلا: أكيد أن المرجعيات الفكرية والسياسية والأيديولوجية، مؤطرة وموجهة للقضايا الثقافية وللتفاعل الثقافي، الفكري، ونوع القضايا التي تطرح على الساحة. إلا أن هذه المرجعيات هي نفسها مؤطرة بما يمكن أن نسميه مناخا عالميا أو بالفترة. وبكل صراحة، أصبحت أميل إلى تصورات بنيوية، إلى محددات بنيوية للفترات/ Époques بمعناها الفلسفي القوي؛ «L’époque» بمعنى أن هناك اختيارات وموجهات ومحددات أساسية. الفترة التي نعيشها منذ هزيمة 67، ومنذ اندلاع الثورة الإيرانية، وفيما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، هي أحداث موجهة تترك آثارا غير مرئية. الفترة هي بمثابة قوس صغير داخل أقواس كبرى. هذا القوس الصغير يمكن تسميته هيمنة المرجعية الإسلامية أو المثال الإسلامي أو الأيديولوجيا الإسلامية أو شيء من هذا القبيل.
ربما هذه هي الأحداث الخلفية الموجهة للاهتمام بقضايا الهوية والأيديولوجيا، بمعنى أن التحولات التاريخية الكبرى هي التي توجه الاهتمام بقضايا معينة، وعلى رأسها قضية الهوية كقضية فكرية، وكمشغل وجودي، واهتمام يطرح نفسه ويقدم تفسيرات أو افتراضات سهلة، وهذا فيما يخص الخلفيات الكبرى، على ما أظن. حتى داخل الاهتمامات الأيديولوجية، نشاهد زخم الإسلام السياسي واندفاعه وسعيه إلى التمكن أو التمكين، بمعنى أنه تولدت لدى حركات الإسلام السياسي قناعات بأن خدمة الفكرة أو الأيديولوجيا الإسلامية تتطلب الوصول إلى السلطة والتمكن من أدوات الفعل والتأثير. فنحن في الحقيقة نلاحظ التحول النوعي الذي حدث في الإسلام السياسي، وهو الانتقال من محورية فكرة النهضة إلى محورية فكرة الهوية. وهذا هو الذي دفع بالموضوع الهوياتي إلى الواجهة.
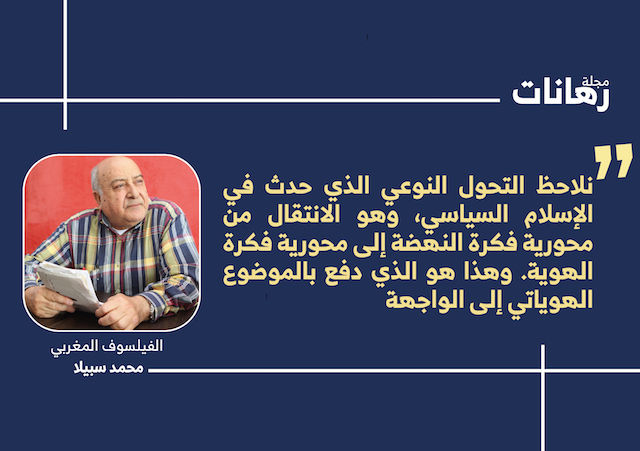
المختار بنعبدلاوي: ألا ترى، أستاذ سبيلا، أن العد العكسي للإسلام السياسي قد بدأ بالفعل؟
سبيلا: الإسلام السياسي في نقطة مفصلية- وأنت أعلم مني بهذا الموضوع- بدأ مع بدايات القرن كرد فعل، بالمعنى الإنجليزي لكلمة "Response"، وانفعال بحدث كبير، أي أن العرب أفاقوا، فوجدوا أنفسهم متخلفين، ثم بدأت النخبة الفكرية تطور فكرا يدافع عن الإسلام ضد الهجمات، والتفاوتات ويفسر أسباب التخلف بالتبرؤ الذاتي منه وبإرجاعه إلى الآخر. ولكن منذ البداية بدأت التوجهات الإسلامية تكتسب طابعا سياسيا بإعطاء الأولوية لما هو سياسي. من ثمة، فإن الخلافة أو الإمامة أصبحت جزءا أساسيا في هذا المشروع. هكذا، بدأ الإسلام الثقافي كرد فعل تجاه الحداثة. ورد الفعل هذا بدأ ثقافيا وأصبح ينحو منحا سياسيا. أعتقد أن الاتجاه نحو السياسة أو الميل نحو السياسة، يتضمن في عمقه مطلب اكتساب القوة لأنه عندما تقدم تصورا سياسيا أو رد فعل سياسي فإنك تفكر في ميزان القوى وبالتالي في أدوات القوة، لذلك بدأ الانزلاق نحو السياسية بتدرجاتها المختلفة من السلم إلى العنف. ونعرف جميعا كيف انتهى مسلسل أو منزلق العنف، وكيف خلق دلك أزمة حضارية، ثقافية وكونية. وأصبحت بعض الاتجاهات الإسلامية مرتبطة بالعنف إلى غير ذلك: من الثقافة إلى السياسة إلى العنف: تلك مزالق التاريخ.
من جهة ثانية، أتيح لبعض تجارب الإسلام السياسي الانتقال من مستوى الدعوة إلى مستوى السلطة، وهذا الانتقال هو انتقال نوعي كبير، خاصة بالنسبة للحركات الإسلامية التي لم تكن مهيأة أو منظمة بشكل حزبي وأيديولوجي لاستلام السلطة.
كان هذان المساران وخصوصا المسار الأخير من أسباب الارتباك في تدبير مسار السلطة. هذا المعطى كان حاسما ونعرف مآله بالخصوص في مصر، رغم أن بعض القوى المهيمنة عالميا دعت إلى احتواء الاتجاهات الإسلامية المعتدلة وترويضها سياسيا عبر اشراكها في السلطة.
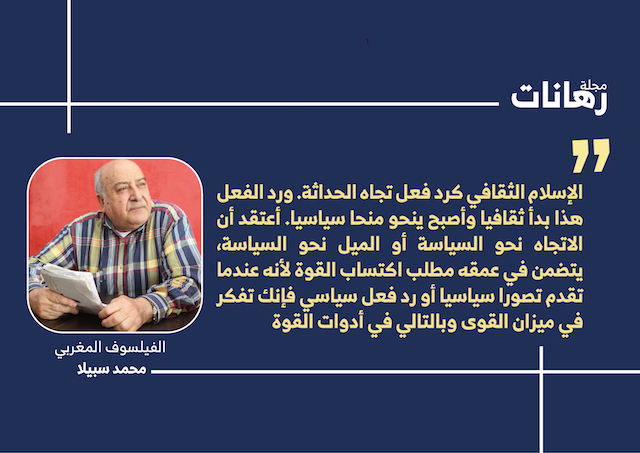
المختار بنعبدلاوي: أريد فقط أن أشير إلى شيء بسيط جدا، عندما ننظر مثلا إلى ضعف المشاركة السياسية في بلد كالمغرب أو غيره، وهو ضعف بين وواضح، نجد أن قوة الإسلاميين الحقيقية لا تكمن في قوتهم الفعلية ولكن في غياب أية حياة سياسية حقيقة، بمعنى في ضعف مكونات سياسية أخرى يمكن أن تكون منافسا لهم، وأن تطرح مشاريع أخرى وأن تقدم بدائل.
سبيلا: مظاهر ضعف الحركات السياسية الحديثة يعود بالضبط لهذه الأزمة، بدأت بالزحف نحو الجميع، فالأحزاب السياسية تقوم عادة على مشروع أيديولوجي، حمولة أيديولوجية ووعود أيديولوجية بالمعنى الطوباوي، فيها بشائر ووعود وتحولات كبيرة. فهذه الحمولة الأيديولوجية الطوباوية لم يعد لها مفعول. بمعنى أن فشل الحركات السياسية التحديثية أو الأحزاب العصرية راجع من جهة، بالنسبة للأحزاب الاشتراكية إلى ضمور المثال الاشتراكي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي الذي كان سندا قويا على كافة المستويات التنظيمية والفكرية لهذه الحركات. إذن هناك أحداث كبرى أدت إلى ذلك.
ثانيا، التحولات البنيوية التي أسميتها قوسا، تميل نحو تثمين أو تحسين الوعود ذات الطابع الأيديولوجي الإسلامي. ولذلك فإن فشل الأحزاب العصرية مرتبط عضويا بضمور أيديولوجياتها ووعودها، وظهور بوادر الفشل في النموذج الاشتراكي. أذكر باستمرار شهادات بعض المثقفين العرب كموقف "كريم مروة" القيادي السابق في الحزب الشيوعي اللبناني الذي كتب مؤخرا بأنه لا وجود لشيء اسمه الاشتراكية، أن الاشتراكية خرافة كبرى وكذبة تاريخية كبرى وهذه شهادة من الداخل. هذا النموذج أو هذه الطوباوية ما عادت تحمل البشائر. التاريخ ماكر ومحتال وقادر على تكذيب اليوتوبيات أو على الأقل تقليم أظافرها. وهذا تحدٍّ تاريخي يطال الجميع.
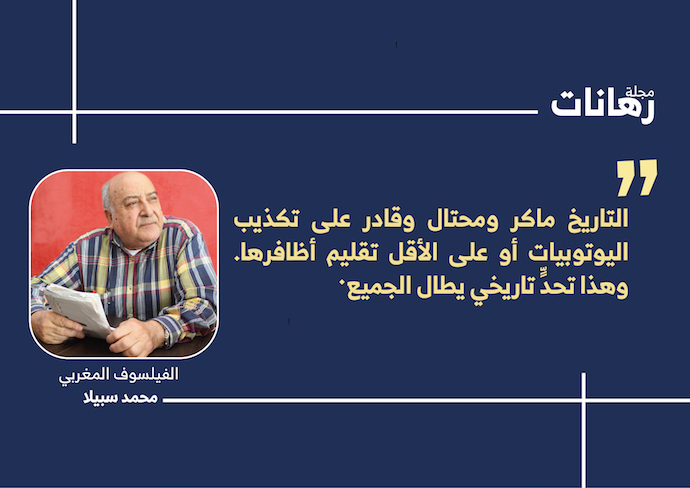
المختار بنعبدلاوي: هنالك عنصر ربط، يمكن أن نربط صعود الإسلاموية كأحد التعبيرات الشعبوية من جهة، والشعبوية الصاعدة في الغرب كذلك؛ يعني أنه لا يمكن أن نغفل أن وجوه التشابه واضحة وكبيرة بين المسارين...
سبيلا: أظن أن الشعبوية الغربية هي شعبوية تعبر عن ضمور أو إفلاس المؤسسات أو التدبير المؤسساتي والوعود والبشائر التي كانت تحملها الديمقراطية، خصوصا بعد تسلط البيروقراطية الرسمية والحزبية. في حين أن الشعبوية الإسلاموية هي شعبوية أيديولوجية وثقافية أكثر. بمعنى أنها ترتبط بقوة الفكرة الدينية وإغرائها، والتي تقدم حلولا دنيوية وأخروية وتقدم تفسيرات شمولية. الشعبوية العربية الإسلامية، هي شعبوية ذات ملامح دينية فيها جانب من مواجهة الحداثة بتقديم وعود وحلول لا تقدمها المؤسسات الحديثة، بتقديم تفسيرات تتعلق بمعنى الحياة، وما بعد الحياة. قوة الشعبوية الإسلامية راجعة إلى ارتباطها بحلول وجودية؛ طبعا إلى جانب استثمارها لفشل الاختيارات التحديثية ووعود الدولة القومية أو الدولة الأمة واستشراء الفساد والبيروقراطية، لكن الحل الإسلامي يحمل وعودا وبشائر أخروية قوية بالنسبة لمجتمعات تسير بتؤدة في درب الحداثة والتحديث، ولا تحقق مكاسب كبيرة على هذا المستوى، ويختل عندها معنى الحياة فتجد هذه التفسيرات ربما قريبة إلى التراث العميق لهذه الشعوب، إذ تجد هذه التفسيرات متوفرة وسهلة وهذا ما يفسر هذه الانسياقات الشعبوية، في حين أن الشعبوية الغربية ناتجة عن فشل المؤسسات، الدولة أو الديمقراطية الحديثة.
جليد: أستاذ سبيلا، بدوري أرغب في إثارة ملاحظة مفادها، أنه بنفس الطريقة، يمكن أن نفسر تراجع دور الفلسفة أو النخبة الثقافية أمام هذا الإغراء الديني الذي تحدثت عنه. فإلى أي حد يمكن في هذا السياق أن ندبر هذا النقاش أو هذه التوترات الاجتماعية السياسية والثقافية والفكرية حول القضايا التي نود أن نناقشها والمرتبطة بالهوية والقيم؟ بمعنى آخر، تحدثت عن الإغراء الكامن في الدين، هل يمكن أن نقول إن هذا الإغراء هو الذي جعل دور النخبة المثقفة يتراجع إلى الخلف؟
سبيلا: النخبة المثقفة صنفان، تحديثية وهوياتية- أو هووية- وهذه الأخيرة نشيطة ومرتبطة بمؤسسات، وتعيش فترة ازدهار إلى حد ما، لأنها مرتبطة بمشروع سياسي مجسد وطموح. في حين أن النخبة التحديثية تعيش حالة تساؤل وحالة نكوص، وتتردد لأن حدثا كبيرا وقع في العالم هو تراجع الاشتراكية والنموذج الاشتراكي الذي كان مكتسحا وظافرا في إحدى الفترات، على الأقل انطلاقا من الثورة الروسية إلى حدود انهيار الاتحاد السوفياتي. إذا، هذا حدث كبير يحتاج إلى تفسيرات واجتهادات ويتطلب التخلي عن الكثير من القناعات والدوغمائيات والتفسيرات الجاهزة التي كانت في المراحل الأيديولوجية السابقة سهلة وتعطي حلولا سهلة. أتذكر هنا بالمناسبة المرحوم أحمد المجاطي، سألته لماذا هذا الصمت الشعري فقال ما يحدث في العالم العربي من تحولات عميقة وامتساخات يجعل المرء يصمت لعدة قرون ليفهم. لأن ما وقع ليس بالسهل ويخلخل المسلمات والبنيات العقلية.
المختار بنعبدلاوي: أذكر فترة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات عندما كنت أزور بيروت أو دمشق أو بغداد لكي أكتشف أن الكتاب المغاربة يتصدرون واجهات عدد من المكتبات، فيما يمكن وصفه بأوج الفكر الفلسفي في المغرب. السؤال هو، لماذا حتى بعد الحظر عن الفلسفة في المغرب، لم يستطع الفكر الفلسفى بالخروج من الدائرة الضيقة للنخبة؟ لماذا لم يكن لهذا الأوج وقع على المؤسسات السياسية ولا على فكر النخب أو على وكأن الفلسفة ظلت في برج ضيق معزول وغير قادر على التأثير؟
سبيلا: كانت النخبة التحديثية تعيش نفس الحالة، وكان ازدهار الفلسفة مظهرا من هذه المظاهر. بعد ذلك حصل انطفاء الجذوات الأيديولوجية التحديثية التي كانت تتمثل في اليسار المغربي. هنا أعود للتفكير في سبب فشل الاشتراكية، ولماذا فشلت الأحزاب الحداثية التي كانت رائدة في التحديث والتنوير؟ وما هي أسباب تحولها إلى بيروقراطيات أو مصالح خاصة أو شيئا من هذا القبيل.لا نمتلك نحن في المغرب بعد جرأة كبيرة على تشريح هذا الوضع لكن هنالك تساؤل، وهنا أتحدث عن نفسي وعن جيلي، لماذا كانت انطلاقة اليسار هذه متمثلة في الاتحاد الوطنى ثم الاشتراكي للقوات الشعبية بقوته الهائلة المحملة بكثير من الآمال والبشائر في العديد من المستويات؟ ما زلنا لا نملك الجرأة على طرح هذا الموضوع لكنه حاضر، وهذا ينعكس على سلوك النخبة المثقفة، وأنا أتحدث عن المشتغلين بالفلسفة. هناك نوع من الانغلاق المؤسسي، لكن داخل هذا الانغلاق هنالك تجددات فكرية عميقة.
المختار: هل كانت الأحزاب، بهذا المعنى، كيانات طاردة للمثقفين؟
سبيلا: في مرحلة معينة كانت الأحزاب في حاجة للمثقفين وكانت حاضنة ومفرخة لهم، وكان هناك اقتران بين الثقافي والسياسي، على الأقل في مرحلة أولى، والتي كان فيها عبد الله إبراهيم، عمر بن جلون، الجابري... هذه مرحلة كانت الثقافة ذات قيمة وذات فعالية وكان المشروع الثقافي في حد ذاته يسند المشروع السياسي الذي يهدف إلى التحول الشمولي. النخبة السياسية كانت مؤمنة بالتحول الثقافي وتعتبره رافدا من روافدها أو قاعدة من قواعدها. بعد ذلك بدأت الأمور تختزل إلى بيروقراطيات حزبية مغلقة انفصل عنها المثقفون والمشتغلون بالتعليم والثقافة، وارتبطت بفئات اجتماعية أخرى. هنا أريد أن أشير إلى أن الأزمة عميقة وذات أبعاد، ولكن في نفس الوقت أقول، ورغم القلة والندرة، هنالك تحولات عميقة في الفكر الفلسفي المغربي، كما تدل على ذلك إنتاجات الفكر الفلسفي الراهن.
جليد: في نفس السياق، إلى أي حد يمكن القول إن السياسي في المغرب فقد زخمه بانفصاله عن الثقافي؟ وهل هذه الفكرة تنفي مسألة تأثير الليبرالية في المجتمع أو الكيان المغربي بعد الانتقال السياسي في المغرب سنة 1999؟
سبيلا: أولا، كشهادة، أقول في مرحلة انطلاق اليسار كان هنالك ترابط عضوي بين الثقافي والسياسي، وأذكر أنه كانت هناك أنشطة فكرية كبيرة أذكر من بينها مشروع التركيبة الاجتماعية في المغرب، الذي كان قد طرح في إطار الاتحاد الاشتراكي. العروي كان حاضرا في هذا المشروع، وبدأ المثقفون الحزبيون يزايدون في الموضوع ويوسعون، فانسحب بهدوء لأنه شعر بأن الأمر أصبح مزايدات حزبية وتمييعا للموضوع. كان هذا في مرحلة معينة أعتبرها مؤشرا من مؤشرات انهيار وتراجع اليسار إذ أصبح يعتبر الثقافة أداة للفعل السياسي مرتبطة بالانتخابات، حيث جاء تنظيم هذه الأنشطة والندوات التي تم التفكير فيها والتخطيط لها باعتبارها أنشطة موازية للانتخابات وبذلك تحولت الثقافة إلى أداة سياسية، وهي إحدى مؤشرات التحول العام الذي حدث فيما بعد. المهم عندي هو أن الأزمة كانت من العمق حيث أحدثت تحولات نوعية جعلت المثقفين يتراجعون ويتقوقعون، وتطغى عليهم النزعة الأكاديمية ويهتمون بمتابعة التحولات الكبرى فى ميدان تخصصهم، وهو أيضا استخلاص لتجربة سياسية بدأت مشرقة وواعدة ومحملة بالبشائر، وتحولت إلى مكاسب ومغانم أو ما شابه ذلك.
المختار بنعبدلاوي: ألاحظ في السنوات الأخيرة ظاهرة مرتبطة بالجوائز الأدبية خصوصا في بلدان الخليج. رغم أن لهذه الجوائز جانبا إيجابيا بما فيه من إعادة الاعتبار للقراءة والكتاب والثقافة، إلا أن المثقف، ومع حضور هاجس الجائزة، أصبح يمارس أحيانا نوعا من الرقابة الذاتية على كتاباته، بل في بعض الأحيان، في الأدب مثلا في مجال الرواية والنقد، نرى أن هنالك من ينسج على منوال قالب محدد يمكنه أن يصل به إلى الجائزة. هل يمكن أن يكون لهذا المنطق أثر على مصداقية الخطاب الثقافي للمثقف؟
سبيلا: أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل المجالات الثقافية، لكن بالنسبة للفلسفة، ظاهرة الجوائز كانت تتويجا لمرحلة إنتاج ثقافي أكاديمي، وربما نتيجة مرحلة أكاديمية معينة. يمكن أن يكون على المدى البعيد هذا التأثير. لكن لحد الآن، بصراحة عندما أتصفح المجلات المشرقية، وأيضا مسألة الجوائز، ألاحظ أن الإنتاجات المغربية، وهذا ليس بمنطق الشوفينية، متميزة على المستوى العقلاني والأكاديمي. أنا أتحدث عن مجال الفلسفة وبالخصوص عن الفلسفة المغربية الحديثة. يعني أن هنالك نبوغا مغربيا سواء من طرف الذين حصلوا على الجوائز أو حتى أصحاب الإنتاجات الحالية المتناثرة في مختلف المجلات العربية. نلاحظ أنه أصبحت هنالك تقاليد عقلانية، ولم يعد هنالك تسيب لفظي وكلامي كالذي نعرفه في بعض المجالات. هنالك أيضا بنية عقلية حجاجية في المقالات والدراسات، ولم تعد هنالك لغة سائبة. لا يمكن أن يدرس هذه الظاهرة إلا السوسيولوجيون على المدى البعيد فيما يتعلق بالمفعول السحري للجوائز، لكن الجوائز المشرقية، لحد الآن، توجت الإنتاج المغربي الجيد الذي يفرض نفسه بجودته وعقلانيته وأكاديميته، وأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام لأنه عندي في نفس الوقت تخوف من السقوط في الشوفينية، ومع ذلك أقر بذلك في الميدان الذي أعرفه الأعمال التي فازت بجوائز مشرقية هي الأعمال مميزة: (انظر نتاجات بلقزيز وحدجامي).
يوجد تحول نوعي. على الرغم من الندرة إلا أن هنالك تميزا وهذه مفارقة يجب الاعتراف بها. أعتقد أيضا أن هنالك تخزينا تدريجيا، وأنا لا أريد تمجيد الأجيال اللاحقة إلا أن الواقع يفرض علي أن أقول بأن هناك قانون التفوق، وقانون التجدد، وهذا الحكم يعود إلى الأشياء التي قرأتها واطلعت عليها عن كثب. السؤال الأساسي هنا، هل سيتطور الحقل الثقافي المغربي فيما بعد نحو المظاهر ونحو السطحية والجري وراء الجوائز والقياس على ما تطلبه الجوائز؟ في المستقبل لا أدري لكن لحد الآن هنالك حماية وحصانة ذاتية للإنتاج الثقافي المغربي نتيجة عقلانيته الخاصة وتوارث بعض التقاليد التي بدأت تفرض نفسها عبر الجيل الأول، ثم جيلنا، كوسيط نقل هذه التقاليد، وجيل ثالث يحافظ على هذه التقاليد بتفوق واضح.
جليد: المسألة التي ينص عليها الدستور المغربي والتي تتمثل في تعدد روافد الهوية المغربية العربية، الأمازيغية، إسلامية، إفريقية، متوسطية، حسانية، أندلسية إلى غير ذلك، تكاد لا تتمظهر في الفضاء العمومي المغربي، كيف يمكن أن ننظر إلى هذه المفارقة؟ ألا يمكن أن نقول بأن هذا التوصيف الهوياتي أو هذا الجلباب الهوياتي، إن صح التعبير، هو أوسع من الجسد المغربي؟ كيف تنظر إلى هذا التنصيص الدستوري؟
سبيلا: البارحة وأنا أشاهد برنامجا تلفزيا، شاهدت فتاة مغربية غنت بالعربية والأمازيغية بنفس الإتقان، وبذلك أقول إن هنالك بعض مظاهر التفاعل والاندماج بين مكونات الهوية المغربية وهو الأمر الذي يحمي المغرب ويدرجه في مخاضات ومدارات الدولة الأمة.
عمليا هنالك مظاهر الانصهار بين مكونات الهوية لدرجة أنه لم تنفلت هذه المكونات لتؤسس مشروعا خاصا لها بالرغم من كل الجهود، لكن في الواقع هنالك انصهار وتزاوج، بين كل المكونات المشار إليها في الدستور. أشعر أن التجربة المغربية في الانصهار الهوياتي، والاجتماعي المغربي أقوى من هذه التعبيرات الثقافية والأيديولوجية التي يشار إليها. هي فعلا من المكونات لكنها لا تملك فعالية الانفراد، ولم تنفلت من الإطار العام الذي يحكم المجتمع وهو صيرورة وسيرورة التفاعل والاندماج التدريجي بين هذه المكونات على المستويين السوسيولوجي والثقافي.